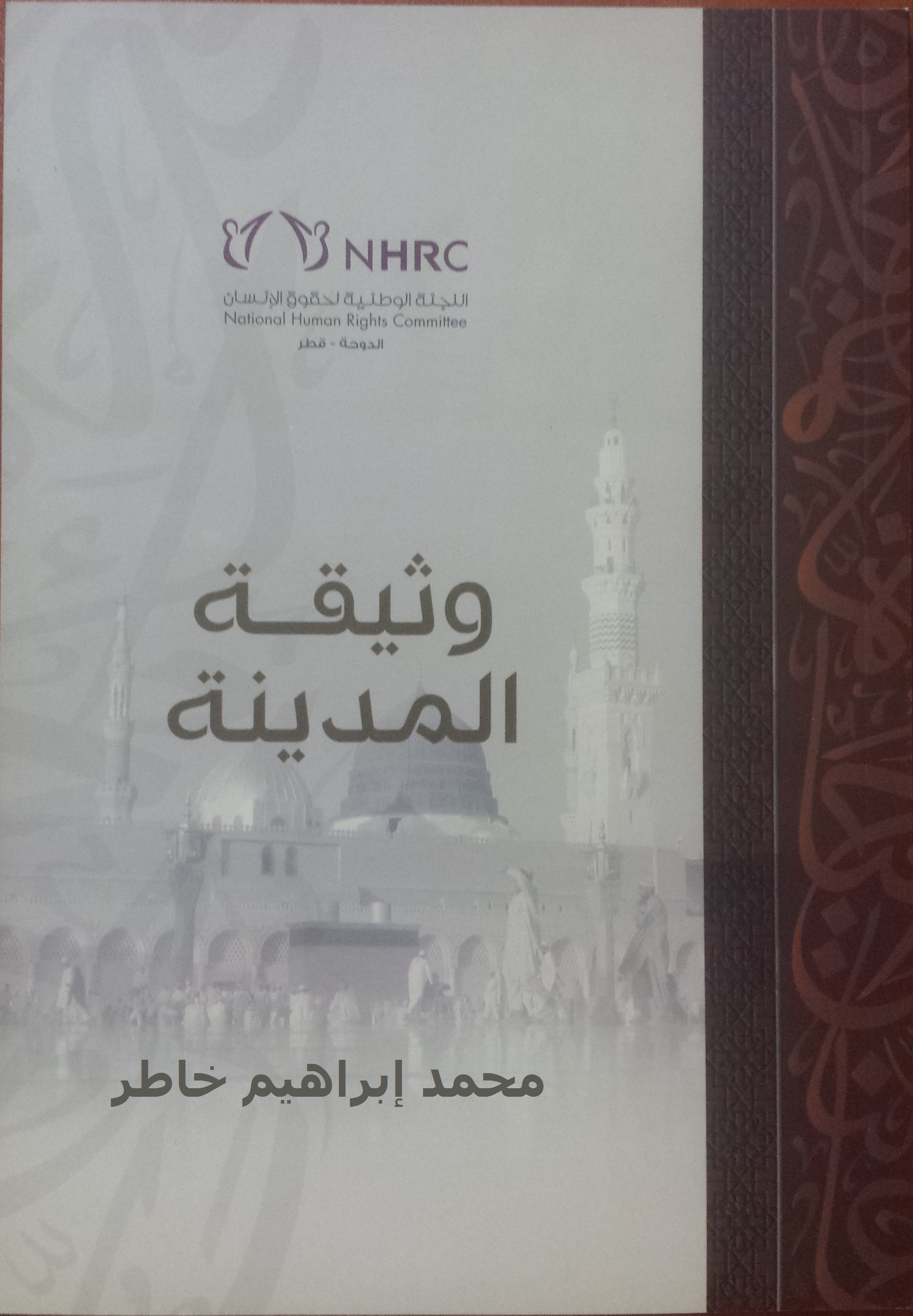يصحّ القول: إنّ الحَبّة لا تصيرُ “قُبَّة” من ذاتِها، إنّما يصيِّرها الإصرارُ على مثل “عنزةٌ، وتطير”. ولا علاقة بين الحبّة والقُبّة سوى هذا التّشابُه اللّفظيّ النّافع في الجناس النّاقص. وما الأمر هنا ببعيدٍ من موت المرء وفي نفسه شيءٌ من ضبط الهمزة في “يُعجبُني سخاؤُها”؛ إذ يُبدع أعضاء لجنة التّحكيم في مسابقة البرنامج التلفزيوني في أبوظبي “أمير الشّعراء” لتأوُّل وجوهِ ضبطِها، ويحارون بين: ضمّ الشّاعر الليبيّ الفَطِن، عبد السلام أبو حجر ونَصْبِ عضو اللجنة، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية عليّ بن تميم، وكَسْر الأستاذة الجامعية المصرية أماني فؤاد، وعجب الأستاذ الجامعي المغربي محمّد حجو من الشّاعر: “عجيبٌ، ويُجيب!”.
ومن الطّريف أنّ الشّاعر تنبّه (يبدو أنّ ثقافتَه أسعفَتْه) إلى الحرَج الّذي سبَّبَتْه “همزتُه”، وأوقعت لجنة التّحكيم فيه، فاستحضر ذهنُه وقيعة الحجّاج بيحيى بن يعمر حين سأله عمّا إذا كان سمعَه يلْحَن، فأجابَه بالإثباتِ، فنَفاهُ إلى خُراسان. ورأى الفتى سيفَ ديموقليس مُصْلَتًا تُمْسِكُه شعرة، فأمدَّته الدّماثة ليجدَ مَخْلَصًا، ويُسقِطَ الهمزةَ بعدُ: “ويُعْجِبُني في الذِّكرَياتِ سَخَاهَا”، مصرِّحًا في تغريدته اللاحقةِ بأنّ “همزته” أوقعَتْه في “بَلَاهَا”. لكنّ الأهمّ: شُكرُه الصّريح تلك المساندة العريضة الّتي أعانَه بها عبادٌ كثيرون، واضطرارُه لتغيير القصيدة كلّها كما قال: “خرجتُ من الإشكالِ حتَّى أُرِيحَهُمْ”، فمن هم هؤلاء الذين أراد أن يُريحَهم؟ قد اضطُرّ الشّاعر إلى الأخذ بمبدأ “سياسة القول” عند ابن رشيق، فهو في الغاية “طالبُ فَضْل”، ولجنة التّحكيم تحملُ سيفَها: “إذا غضبتْ عليكَ بنُو تَميمٍ…”.
أن يلحَن المرءُ العربيّ القُحُّ، بل الأعرابيُّ الباقي على فِطرتِه اللغويّة المُنَمَّاة بالسّماع، أمرٌ عاديّ، وقد لحَن كِبارٌ من أهل العربيّة، وصحّف وحرّفَ حتّى أهل الحديث، ولحنَ الحجّاجُ بن يوسُف مُعلِّم القرآن في الكتاتيبِ في خبرِ كانَ، فرفَعَهُ (كانَتْ … أَحَبُّ)، وطلب النبيّ الأكرم من أصحابه أن يُرشِدوا الأعرابيّ حينَ لحَنَ، ولاحق النّحاة والمتطفّلون على الشِّعر الفرزدقَ وأبا تمّام والمتنبّي؛ حتّى ردّ الأوّل على ناقدِه: “لنا أن نقول، وعليكم أن تتأوّلوا”، وردّ الثّاني على أبي العميثل: “وأنتَ، لمَ لا تفهَمُ من الشِّعر ما يُقال؟”، وحتّى قال المتنبّي: “أرى المُتَشَاعِرِينَ غُرُوا بذمِّي”. هذا مع أنّ الخليل بن أحمد قال قديمًا (زهر الآداب: 3/687): “الشُّعراء أُمراء الكلام، يصرِّفُونَه أنّى شاؤوا، وجائزٌ لهم ما لا يجوز لغيرهم”.
الرُّكنَ المهيبَ في اللّجنة أخطأ في الإعراب، ومالأتْهُ شريكتُه، وسكتَ الثّالثُ على الأمر سُكوتًا عن الحقّ إن كان يعرفُه، وثبَتَ على تخطئة الصّواب
لكنّ القضيّة هنا مختلفة تمامًا، وهي في العلمِ أوقعُ منها في اللّحن؛ إذ إنّ عُضوين من اللّجنة حَكَما بتَخْطئة الصّواب، وأصرّا على خطأيهِما في حين تضاحك الثّالثُ متعجِّبًا، وطلبا من الشّاعر أن يخرَج في استراحة ليُراجعَ نفسَه ويعودَ “ليعترفَ” بخطأ صوابِه، وصوابِ خطئهما، مع أنّ الموقف كان يستدعي من اللجنة أن تُراجعَ هي نفسَها، وتناقشَ ما بدرَ من خلافٍ بين عضوين منها على الأقلّ، وتعترفَ بخطئها. وقد كان في مُكْنَتِها أن تحذف هذا المقطع من الحلقة المسجَّلة بالمونتاج قبل بثِّها، أو تعيد تسجيل المقطع بما يبيِّن هذا الذي كتبه عضو اللجنة، علي بن تميم، بعدُ في تغريدته، وأراد به تبرير خطئه، لتتضمّن الحلقةُ حين تُبَثُّ ما يدلّ على رغبتِها في “استفزاز” المتسابق للتثبُّت من معرفته. أمّا وقد بُثّت الحلقة على حالها، فلا وجهَ للتّبرير، ولا مجال لتصديق أيّ سببٍ غير أنّ الرُّكنَ المهيبَ في اللّجنة قد أخطأ في الإعراب، ومالأتْهُ شريكتُه، وسكتَ الثّالثُ على الأمر سُكوتًا عن الحقّ إن كان يعرفُه، وثبَتَ على تخطئة الصّواب.
أن يلحَن المرءُ أو يُخطئَ أمرٌ مألوف، على تبايُنٍ بين النّاس في مقدارِ اللَّحن والخطأ ومواضعِهما. فإذا عرفَ اللّاحنُ موضع لحنِه، والمُخطئ وجهَ خطئِه، واعترفَ به فأصلَحه، أبقَى الحبّة على “حَبِّيَّتِها”، ولم “يُقَبِّبْهَا”. فإذا أصرَّ على خطئه نَفَشَ “الحبَّةَ”، وقد يزيدُ الأمرَ سُوءًا فيحاول تسويغَ الخطأ ليقعَ في رِبقةِ التّبريرِ العاجزِ، ويتنامى الخطأ ليُصبحَ مُركَّبًا، ويتضاعفَ معه حجمُ “الحَبَّة”. والذي يقطع طريقَ العودةِ إلى الصّواب هو اتّهام الواقفين على خطئه بأنّهم “مُتعالِمُون”، ثمّ رُكوب أعلى ما في خَيْلِه ورَمي كلّ مَن ساندَ صوابيّة الصّواب، وبيّن خَطَئيَّةَ الخطأ، بضُروبٍ من الهرطقة والزّندقة وفنون من التّدليس والتّلبيس، كما ظهر في الرّدّ على ما أثارته مواقع السّوشيال ميديا. اتّهم الرّادُّ كلّ أولئكَ بأنّهم “إخونجية”، وكلّ المواقع والصّحف والمحطّات بأنّها تابعة للإخوان المسلمين، وكأنّهُ يملك فيصل التّفرقة بين العرب جميعًا بتصنيفهم: إخوانًا وغيرَ إخوان، وهذا طريفٌ يذكِّر بقول أحمد مطر: “في الأرض مخلوقانْ؛ إنسٌ وأمريكانْ”. هكذا صارت الحبّة قُبّة: “صوابُكَ خطأ، وكلّ من يراكَ مُصيبًا ويراني مُخطئًا مُتَعالِم، ثمّ كلّ من يُسانِدُك ويُخالفُني إخوانيّ”.
الخطأ مقبولٌ من الناطق العاديّ بالعربيّة، وغير مقبولٍ من الأكاديميّ المتخصِّص الذي يُفْتَرضُ بُلوغُه من العلم منزلةً أهّلتْه لنيل شهادة الدّكتوراه في النّقد الأدبيّ
لكنّ السّياق في حدّ ذاتِه عجيب؛ فالخطأ مقبولٌ من النّاطق العاديّ بالعربيّة، وغير مقبولٍ من الأكاديميّ المتخصِّص الّذي يُفْتَرضُ بُلوغُه من العلم منزلةً أهّلتْه لنيل شهادة الدّكتوراه في النّقد الأدبيّ، ثمّ جعلت منه بعدُ عُضوًا في لجنة تحكيم جائزة أدبيّة خاصّة بالشِّعر، بل باختيار “أمير الشّعراء”. والعجيبُ رَفْضُ الاعتراف بالخطأ وإن بتخريجه على وجهٍ من وُجوه الدُّعابة، أو الاختبار والرّغبة في التّثبُّت من معرفة المتسابِق بالإجابة. والأعجبُ أن تميل المحكَّمَة الأُخرى كُلّ المَيل لتُوافق الرُّكنَ المَهيبَ في اللجنة، ثمّ لتخالفَه غيرَ عارفةٍ وجهًا لما تقولُ، فصارت مثلَ كَيْسان مُسْتَمْلي أبي عُبيدة: يسمع غير ما قِيل، ويكتب غير ما سَمِع، ويقرأ غير ما كَتَب، ويفهم غير ما قَرَأ. والعُجَابُ الّذي زاد الطّين بلّةً تلك التّغريدة الّتي حاول بها علي بن تميم أن يبرِّر وقوعَه في الخطأ (الحبَّة)، فورّط نفسَه في (قُبَّة)، فلم يتلقَّ أحدٌ محاولتَه بالقبول.
كانت المسألة برمّتها أيسر من هذا جدًّا: “أخطأتُ، وأُقرُّ بصواب إعرابِ المتسابق”. ولو أنّ علي بن تميم فعل ذلك، لما صارت “الحَبَّة قُبَّة”، ولانتهت المسألة عند هذا الحدّ، ولَما نالَ ذلك من أهليَّة لجنة التّحكيم إلّا بقدرٍ بسيطٍ، لا من مصداقيّتها.
لكن: هل يمكنُ حصرُ القضيّة في هذا النّطاق الضّيّق؟ ينفتحُ المشهدُ بهذه “الحَبّة القُبّة” على واقعِ لجان التّحكيم في المسابقات والجوائز؛ كيف يُختار أعضاؤُها؟ أهُمْ مُؤهَّلون حقًّا ليحكِّموا تلك الجوائز والمسابقات؟ ويمتدّ ليَطُول واقع التّعليم والثّقافة والأكاديميا والفِكر: لم لا يُقرُّ المخطِئ بخطئِه، ويركبُ رأسَه في إصرارٍ عجيبٍ على الخطأ؟ وبأيّ منطقٍ يجدُ مُخطِّئ الصّوابِ من يُساندُه في التّخطئة ويُبرِّرها له؟ ولعلّ الأخطر: بأيّ سُلطةٍ يُضْطَرُّ المُصِيبُ إلى أن يغيِّر صوابَه، ويتجرَّع مرارةَ التّخطئة، بل يُعاقَب على صوابه الّذي قد يُوقِع أستاذًا، أو محكّمًا، أو مُناقشًا لرسالة جامعيّة، أو صاحبَ عمل، أو مُديرًا، في الحرَج؟ .. هذا يمسُّ جوهر المعرفة، وجوهر المنطق، وجوهر العقل، وجوهر النّقد، وجوهر الأخلاق، وليس خطأ القول: إنّه يمسّ جوهر الوجود الإنسانيّ، ويُطيحُ احترام الذّات الإنسانيّة وكينونتَها.
بأيّ سُلطةٍ يُضْطَرُّ المُصِيبُ إلى أن يغيِّر صوابَه، ويتجرَّع مرارةَ التّخطئة، بل يُعاقَب على صوابه؟
سمعتُ مقاطعَ لصانع القُبّة من الحبّة، في اليومين الأخيرين، رغبةً في البحث عن وجهٍ لسَقْطَتِه، فسمعتُ كلامًا على التّنوّع والتّعدُّد وقبول الآخر والانفتاح على الأفكار… إلخ، حتّى وقع المرءُ في حَيرةٍ من أمر هذه الازدواجيّة بين الكلام والتّطبيق، وهي، على كلّ حال، ازدواجيّة تطاول مثقّفي السّلطة في عالمنا العربيّ، وتبلغ بهم حدّ التّناقُض المقيت الّذي تنفر منه حتّى العامّة على طريقة “أسمع كلامك أصدّقك، أشوف عمايلك أستعجب!”. ويكاد المرء يُوقن أنّ هذا النّمط من مثقّفي السّلطة لا يملكونَ خطابًا يُماسُّ الحقائق، أو يقدّم حُلولًا لمشكلات مجتمعاتِهم، وقُصارى جُهودهم لا تتجاوز الذّرائعيّة والتّسويغيّة والتّجميليّة والتّهجُّم، ويتراوحُ أمرُهم بين تخطئة الصّواب وتسويغ الخطأ.
لكنّ الوجه المُشْرِق لهذه “الحبّة القُبّة” ماثلٌ في التّفاعل الواسع عبر السوشيال ميديا: تعاطُفًا ومساندةً وتصويبًا وتأكيدًا ومُباركةً وتثمينًا ورِضًى وإعجابًا بمعرفة أوّليّة بسيطةٍ أبداها الشّاعر الشّابّ حين بيّن وجْه الإعراب في “سخاؤُها”، وتقريعًا وتأنيبًا وتسخيفًا وعَذْلًا وتتفيهًا وسُخريةً وسخطًا ونقضًا وبيانًا تعليميًّا لأعضاء اللّجنة في أساسيّاتٍ أوّليّة في النَّحْو العربيّ، يبدو أنّ أعضاء اللجنة لا يملكونَها. هذا التّفاعل الذي بلغ قرابة 600 ألف مشاركة وتعليق في أيّام معدودات، وأكثر من مليون إعجاب بإجابة الشّاعر الشّابّ، يؤكّد وعيَ العربِ بلغتِهم من جانب، ووقوفَهم إلى جانب الصّواب من آخَر، فضلًا عن أمر في غاية الأهمّيّة هُو: ابتذالُهم لتخطئة الصّواب بجهالة، واسترذالُهم لكلّ محاولات التّبرير الواهية، ورفضُهم لاتّهامهم بالغوغائيّة والتّعالُم. ولعلّ الدّلالة الأقوى في هذا التّفاعُل هي تلك الكاشفة عن سُقوط أثر سيف ديموقليس المُسْلَط على الرّقاب، سلطة المال والفُرَص والأحلام؛ فالجميع يعرفُ أنّ فُرصتَه قد تضيعُ حين يُدلي بدلوِه في النّقد؛ لأنّه سيُصنَّف على قائمة “الإخوان” باطلًا، وما هُو منهم، ولا هُم منه في شيء.
المصدر: العربي الجديد