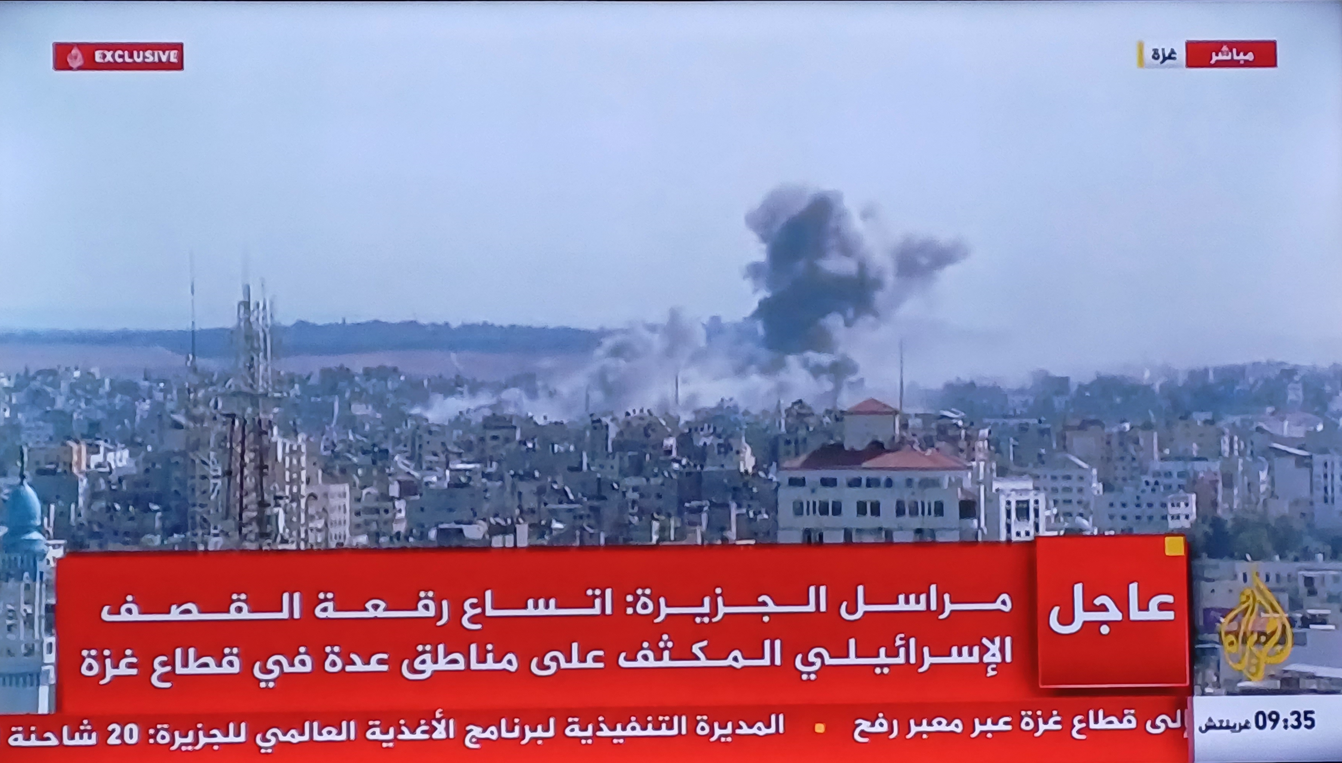المثقف وتحديات الإصلاح الديني..”١” *

الدكتور النور حمد
مقدمة:
تحفل الأدبيات الأكاديمية العربية، التي كُتبت في العقود القليلة الماضية، بعديد المقاربات التي تناولت مسألة المثقف؛ كيف نشأت كظاهرة؟ من هو المثقف؟ ما هي مواصفاته؟ ما هو دوره، ورسالته؟ وما هي الاشكالات التي تعتور علاقته بذاته، وبالسلطة، وبالمجتمع؟ تناول هذه القضية كتابٌ عربٌ بارزون. أذكر منهم على سبيل المثال، لا الحصر: عبد الله العروي، علي حرب، برهان غليون، محمد عابد الجابري، هشام شرابي، عزمي بشارة، علي أومليل، إدوارد سعيد، هادي العلوي، عبد العزيز بلقزيز، سمير أمين، زهير توفيق، وآخرون. ولقد قدم هؤلاء، جميعهم، كما قدم غيرهم، اسهامًا مقدرًا في إضاءة جوانب هذه القضية. لكن، على الرغم من كل تلك الكتابات الثرة، التي تناولت هذه القضية متعددة الجوانب، واحتوائها جهدًا بحثيًا وفكريًا قيمًا، أنار كثيرًا من زواياها المعتمة، إلا أن بعض جوانب هذه القضية، لا تزال تحتاج، في تقديري، مزيدًا من الاضاءة. ويهمني في هذه الورقة أن أتناول أحد جوانبها غير المطروقة، وهو غياب المثقفين العرب الحداثيين عن معركة التجديد الديني، ونقص اهتمامهم بها، وعزوفهم عن الانخراط فيها، وتركها لمن يسمون “رجال الدين”.
في مؤلفه الضخم، الدين والعلمانية في سياق تاريخي، الذي عالج فيه، بصورة موسوعية، الجدلية التاريخية للدين والعلمانية، يقول عزمي بشارة: “الدين ليس مجرد وعيٍ زائف، وكما أن اختزاله في ذلك يحجب رؤية الظاهرة الدينية في غناها”1. ولقد اخترت الابتداء بهذا التنبيه، لكونه تنبيهًا شديد الأهمية. فهو يراجع، من وجهة نظري، نزعةً فشت، منذ فجر حقبة الحداثة في أوساط
قطاع عريض من المثقفين، من بينهم بعض المثقفين العرب. مرتكز تلك النزعة، أن الدين ظاهرةٌ ماضوية، ارتبطت، إلى حدٍّ كبير، بطفولة العقل البشري. جرى اختزال فهم الظاهرة الدينية، لدى قطاع مؤثر من الحداثيين، في الاعتقاد بأن الدين ما استمر بوصفه وسيلةً لتفسير الظواهر، وأداةً لإضفاء المعنى على الوجود الانساني، إلا بسبب تخلف العلوم في الماضي. وبما أن العلوم تقدمت، وأصبحت تفسر الظواهرَ، تفسيرًا “علميًا”، فإن مصير الدين الحتمي أن يتراجع، وباستمرار، حتى يختفي، أو ينزوي في الجيوب القصية، التي لم يطلها العلم والتعليم والتنمية.
هذه العقيدة الحداثية التي سيطرت على بعض النخبة المثقفة في الغرب في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وقسطًا معتبرًا من القرن العشرين، انتقلت وسيطرت على رؤى كثير من المثقفين العرب الحداثيين، خاصةً بُعَيْدَ منتصف القرن العشرين. ويمكن القول، بصورة مجملة ــ والاستثناءات قائمة بطبيعة الحال ــ إن المثقفين العرب انسحبوا من ساحة التجديد الديني، خاصة في الحقبة التي سيطر فيها اليسار العروبي على الحكم في الأقطار العربية المفتاحية، في النصف الثاني من القرن العشرين، وأصبحت الماركسية والدارونية الاجتماعية، مجتمعتين، عاملين مؤثرين في النظر إلى الدين، باعتباره ظاهرة منقرضة، مصيرها الاضمحلال، كلما تقدم الزمن، وأنها لن تلبث، بمرور الزمن، أن تتلاشى تمامًا.
كان الظن وسط قطاعٍ كبيرٍ من النخب العلمانية، المتأثرة بطروحات المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية، أن الدين سيموت موتًا طبيعيًا، كلما تقدم التصنيع، وتغيرت علاقات الإنتاج، ونمى الاقتصاد. وقد شارك الليبراليون من المثقفين العرب، على اختلاف منطلقهم الفلسفي، المثقفين المرتكزين على الطروحات والتصورات الماركسية، نفس الاعتقاد المضمر، القائل بالتلاشي التدريجي للدين. بهذا، وقف قطاعٌ شديد الحيوية من مثقفينا على رصيف الفعل، في ما يتعلق بالعمل على تخليق وعي ديني أرقى وسط الجمهور، هو خامة التغيير. واكتفى هذا القطاع بالمراقبة، انتظارًا لتراجع التصورات الدينية للكون والحياة، بزعم أن ذلك حتمية تاريخية.
الرؤية القائلة بحتمية تلاشي التأثير الديني، والانتظار السلبي، الذي ترتب عليها بأن الدين سوف يخلي الساحة، بفعل التحديث ومرور الزمن، قاما، في نظري، على تقديرين
خاطئين. فقد انطويا، في ما أحسب، على نقص في التقدير الصحيح، والعميق، للظاهرة الدينية، وتجذرها في أعماق وعي الفرد البشري، في مختلف الثقافات. فالدين نشأ حيثما وُجدت الجماعة البشرية. وقد اصطحب الإنسان منذ عهود موغلة في السحق. ومع ذلك، ظلت النظرة العلمانية، أو ما يمكن أن نسميه “الدهرية”، قبل نشوء مصطلح “علمانية”، ظلت تتبادل مع النظرة العلمانية مِقْوَدَ التوجيه في الحياة البشرية، عبر حقب التاريخ المختلفة. وقد ظل يجري منهما، ذلك التناوب، في انفصال أحيانًا، كما يجري في تداخل، أحيانًا أخرى، مع غلبة شق على الشق الآخر.
يقول فراس السواح، إن ما يتردد من أن الفلسفة الإغريقية قد وضعت حدا للفكر الديني والميثولوجي، يسير مع الفرضية القائلة بأن الدين يمثل شكلاً أدنى من أشكال النظر العقلي، وأن الفلسفة تمثل الشكل الأرقى، والأعلى. ويرى السواح أن هذه المقولة لم تخضع للنقد، وقول السواح بأنها لم تخضع للنقد، ينطوي، في حد ذاته، على تنبيه مهم. لأن بقاء تلك المقولة من غير نقد، تسبب في أن يسود القبول بالتقسيم المعتاد لتاريخ الفكر الإنساني، بأن له أربع مراحل هي: السحر، فالدين، فالفلسفة، فالعلم التجريبي. ويضيف السواح، أن الفلسفة الإغريقية لم تكن سوى بارقةٍ عارضةٍ، ما لبثت أن انطفأت أمام مد الفكر الديني والأسطوري. إذ تراجع بعدها الفكر الفلسفي لعدة قرون، قبل أن ينبعث، مرة أخرى، في العصور الحديثة، متوكئا على عصا عربية، أبقت على شيء من أقباس الفلسفة، لكن على الأطراف الخارجية لثقافة دينية مسيطرة. ويرى السوّاح أن ذلك انطبق على الثقافة العربية، والثقافة الأوروبية الوسيطة. أما العلم، فرغم الأرضية الصلبة التي فرشتها أمامه الفلسفة، آنذاك، فقد بقي أسيرًا للتصورات الدينية والأسطورية، حتى أينعت ثمار عصر النهضة في أوروبا. فبمجيء كوبرنيكوس بنظريته الجديدة عن النظام الشمسي، بدأ استقلال العلم عن الدين والأسطورة، وتبع كوبرنيكوس غاليليو، ثم نيوتن، فكان لهؤلاء فضل وضع أسس التفكير العلمي الحديث2.
النظرة النقدية للتحقيب التي أوردها السواح، ربما قادتنا إلى أن ننظر في تاريخ جدلية العلمانية والدين، بوصفها يشاركان تاريخًا متداخلاً، أكثر من كونها يتواليان في تاريخٍ متعاقب. ولهادي العلوي نظرة للتاريخ الإسلام تنحو هذا المنحى في القول بتداخل التاريخ. يرى العلوي، أن الموجات الفكرية، في التاريخ العربي الإسلامي، ليست متتابعةً، أي، أنها لا تسير في خط مستقيم، متحركةً من الأدنى إلى الأعلى. وإنما هي موجاتٌ متداخلة، تحتل فيها، أحيانًا، الرؤى التنويرية المتقدمة أمكنةً في الزمن الأبكر من السيرورة التاريخية، في حين تحتل فيه، أحيانًا، الرؤى المتخلفة، أمكنةً في الزمن المتأخر، أي؛ الأقرب، والأحدث. يستشهد العلوي في ذلك بقوله، إننا حين نجد أن أبا العلاء المعري، في القرن الحادي عشر الميلادي، (363 -449 هـ )، (973-1057 م)، يعلن ثورةً تنويريةً ، نجد في القرن العشرين، والقرن الواحد والعشرين، من يدعون إلى إقامة الدولة الدينية3، بل، وإلى هيمنة ديانة واحدة على كل شيء. وبطبيعة الحال، فإن ذكر العلوي للمعري، كان مجرد مثالٍ واحد، لأن تاريخ الفكر الإسلامي مليءٌ بالرؤى المتقدمة، التي يصعب قبولها حتى وسط قطاع معتبر من متعلمي، بل ومثقفي الحاضر.
لم تعد التيارات الأجد في الفكر الغربي، تقبل فكرة الأضداد التي تسير في خطوط متوازية فلا تلتقي، أو قل لا تتعايش، وإنما تتعاقب فقط. تتجذر هذه الفكرة عن ثنائية الأطر المعرفية، والقول بتوازي الأفكار وضديتها، في أصلها الأصيل، في ثنائية فكر الحداثة نفسه. يقول هيوستن سميث، إنه منذ أن اختار ديكارت أن يمخر بعيدًا عن الذات، أو النفس المؤسطرة؛ أي، عندما اختار أن يبتعد بتلك النفس عن بقية العالم، جرى غرس الثنائية في تراب الأبستمولوجيا الحديثة، وهكذا بقيت في مكانها. فقصة الفلسفة الغربية برمتها، في مرحلتها الحداثية، يمكننا أن نرويها، اليوم، بوصفها بحثًا مستمرًا عن جسر يربط بين العقل وبيئته المحيطة، وبين الذات والموضوع، التي سبق أن باعد بينهما ديكارت4.لذلك، فإن ما يتصوره البعض تضادًا وتوازيا ثابتًا بين الدين والعلمانية، تراه التيارات الأحدث، مجالاً متداخلاً، له طرفان، يسهمان بحوارهما ونقدهما لبعض، في انتاج سيرورة كلية واحدة. فالعلمانية، بوصفها نزوعًا للعقلنة، انبثقت من داخل بنية الدين
نفسها، كما في حالة الكاثوليكية والبروتستانتية5. وفي المقابل، فإن القول عن ارتباط الروحانية جذريًا ببنية العقل والنفس البشرية، كما في تيارات ما بعد الحداثة، انبثق من قلب الفكرة العلمانية، نفسها، وهي تراجع طروحاتها. لكل ما تقدم، يعد الناقدون لبرادايم الحداثة، تجفيف الحداثة للروحانية في عالم اليوم، مجرد انقلاب متعجل على سيرورة بالغة الطول. ويرونه غير متسق مع البنية الكلية لتلك السيرورة الطويلة التي امتدت منذ فجر الخليقة حتى فجر العصور الحديثة. يقول موريس بورمان، إن التاريخ الإنساني ظل، ولأكثر من 99% منه، تاريخًا مروحنًا، رأى الإنسان نفسه فيه جزءًا متكاملاً مع العالم. وقد أحدث العكس الكلي لهذا التصور، والذي حدث في الأربعمائة سنة الأخيرة، تحطيمًا لاستمرارية التجربة البشرية، ولتكاملية البناء النفسي للإنسان6.
غموض الوجود ولغز الموت:
لا تود هذه الورقة أن تناقش قضايا فلسفية أصولية؛ فلا مرتكز طرحها، ولا حيزها، يسمحان بذلك غير أن الأسئلة الوجودية الكبرى تظل عنصرًا مؤثرًا، وعلى الدوام على أفكار الناس ومسلكهم، ومختلف خياراتهم، يستوى في ذلك العلماء، والبسطاء. كما وضح، من الناحية العملية الواقعية، أن قضية النهضة، في السياق العربي، لا تملك أن تتجاوز مناقشة الدين، والمفاهيم الدينية. ومناقشة الدين تستدعي بالضرورة سؤال المعنى، وسؤال الأخلاق تلقائيا. فالوجود كظاهرة، كان، ولا زال، ظاهرة محيرة، وكذلك الموت. وما من شك أن هاتين الظاهرتين ستبقيان غامضتين، مهما تقدمت المعارف، في العلوم الطبيعية، وفي الفلسفة، وفي اللاهوت، أيضًا. الأسئلة حول هاتين الظاهرتين لن تجد، في يوم من الأيام، إجابةً حاسمةً، وذلك لسبب بسيط، هو تعذر إحاطة الجزئي بالكلي، أو كما يقول المتصوفة، إحاطة “الحادث” بـ “القديم”. أو كما يصور ذلك كين ويلبر، بصورة أخرى، في مجازٍ، أسماه: “راسم الخريطة الذي هو ليس جزءًا منها”. اختار كين ويلبر ذلك المجاز ليقرب الصورة إلى الأذهان في ما يتعلق بنقده لمقولة الفصل بين الذات والموضوع، وتصور أن الإنسان يسعى لفهم العالم من موقع الاحساس بأنه؛ أي الإنسان، كيانٌ مستقلٌّ عن العالم. أو بوصفه، كيانًا غير محكوم بقوانين الكوسموس cosmos، على ذات النسق الذي يهيمن به الكوسموس على عناصر الطبيعة الأخرى. فالإنسان يحاول أن يفهم العالم، مستندًا على فلسفة حقبة الحداثة الموسومة لدى مفكري ما بعد الحداثة بـ “العلموية”، وفي ذهنه أنه مجرد راسم لخريطة هو ليس جزءًا منها، متوهمًا استقلالاً عن بنيتها، بقدر يمكنه من فهمها بصورة كلية، بل والتحكم فيها. هذا في حين أنها محيطة بعقله، وخياراته، مثلما هي محيطة بعناصر الطبيعة الأخرى، ولكن في مستوى مختلف7.
الشاهد أن المعارف البشرية معارف نسبية، وهذا بديهي، كما أنه ليس المهم هنا. المهم حقيقة، أن المعارف البشرية ستظل نسبية، وهي في نسبيتها هذه ستظل، على الدوام، بعيدةً كل البعد عن الحقيقية، مهما تقدم الزمن. وأعني هنا تحديدًا، المعرفة المتعلقة بمحاولة استكناه الجوهر. فإذا صح ما تقدم، وهو عندي صحيح، فإن الدين سوف يبقى، على تعدد أنماطه، ملجأً لغالبية البشر. وسيظل بتجلياته الروحانية المختلفة، المنهل الأقدر على إرواء عطش المعني الأزلي لدى الناس بمختلف ثقافاتهم. كما سيبقى ملجأ الغلبة الغالبة منهم، من أجل الراحة النفسية من المخاوف الوجودية، المتمثلة في هواجس العواقب الأخروية، وهي هواجس بالغة القديمة تعود نشأتها إلى اللحظة التي واجه فيها الإنسان قوى الطبيعة، لأول مرة، فاسترهبت عقله، وسحرت وجدانه.
بعيدًا عن تلك المخاوف والهواجس التاريخية الموغلة في القدم، التي لا تزال تراوح مكانها في النفس البشرية، حيثما وُجدت، فإن غموض ظاهرة الوجود، والاحساس لدى الأكثرية من البشر، بعدم القدرة على البت في ماهيتها بصورة حاسمة، كان له أثره الكبير، لا على عامة الناس وحسب، وإنما على أكبر العقول العلمية، أيضًا. فعلى سبيل المثال، نجد أن تشارس داروين وألبرت آينشتاين، وهما من أبرز العلماء، الذين اشتغلوا في مجالين علميين متصلين بالبحث في الظاهرة الوجودية، بقيا متمسكين بنوع من الإيمان الديني. هذا مع أنهما قلبا، في مجاليْ تخصصهما، المفاهيم التي سبقتهما، رأسًا على عقب. هذا فضلاً عن أن طائفةً كبيرةً من الفلاسفة، وعلماء الإنسانيات، بقيت محتفظةً بإيمانها الديني، بصورة من الصور، والنماذج في ذلك مستفيضة. لذلك، ربما جاز القول، أنه لا توجد علاقة ارتباط شرطية بين التعمق في المعرفة في العلوم الطبيعية، والعلوم الانسانية، وبين الابتعاد عن الإيمان الديني، لا في الماضي، ولا في الحاضر. بل، ربما، ولا في المستقبل، أيضًا. فالربط بين تقدم المعارف في العلوم الطبيعية، والعلوم الإنسانية، وتراجع الدين، أو الروحانيات، ربطٌ، يمكن أن نصفه، بأنه ربط تبسيطي.
الإسلام دين ودولة:
الأطروحة المركزية في هذه الورقة هي أن هناك واجبًا تاريخيًا، لم يطلع به المثقف العربي، كما ينبغي. ذلك الواجب هو ضرورة الانخراط في جهود الإصلاح الديني، وإدارة الحوار حول قضية الدين، من داخل بنية الدين ذاتها، لا من خارجها، وحسب. فمناقشة قضية الدين من خارجها، في السياق العربي، من غير قدر من الانخراط فيها من داخلها، كالحرث في البحر. فلقد جرب المثقفون العلمانيون – وأعني هنا العلمانيين الفلسفيين، ولا أعني العلمانيين دعاة فصل الدين عن مؤسسة الحكم – ذلك النهج منذ نهايات القرن التاسع عشر، من غير أن يكون له مردود يُذكر.
استطاعت كثير من الثقافات الإنسانية على كوكب الأرض أن تدلف إلى ساحة التحديث والنهضة، دون اشكاليات كثيرة. ويمثل شرق آسيا في ذلك نموذجًا واضحا. وما من شك لدي أن ما أعاق النهضة والتحديث في الفضاء العربي، هو المفاهيم الدينية، وأعني هنا تحديدًا، المفاهيم الدينية الإسلامية. يضاف إلى ذلك، سلطة المؤسسة الدينية، وارتباطها بالقوى المسيطرة على الثروة والسلطة. سيبقى التحديث قشرة خارجية، لا تتعدى المظهر الخارجي، ونمط أسلوب العيش، ونزعة الاستهلاك، ما لم يجر حوار معمق ينبثق من داخل بنية الدين نفسها. وسوف يرد ذلك لاحقًا.
النصوص القرآنية قطعية الثبوت، والدلالة، تقول إن الإسلام دين ودولة. فقد ورد في سورة المائدة، “ومن لم يحكم بما أنزل الله، فأولئك هم الكافرون8”. وقد ورد نفس هذا المعني، بصور مختلفة، في آيات أخرى في نفس السورة، مع تنويع في الفاصلة فقط. انتهت الآية 45 بفاصلة: “فأولئك هم الظالمون9”. وانتهت الآية 47، بفاصلة: “فأولئك هم الفاسقون10”.
الاعتقاد في أن تحكيم الدين في حياة الناس معاشًا ومعادً، واجب ديني ملزم لكل فرد، هو ما قام عليه مفهوم “الحاكمية” في فكر الإخوان المسلمين، وغيرهم من دعاة الدولة الدينية وما أسموه، “تطبيق شرع الله”. فالفهم السائد هو أن المسلم يبقى مقصرًا، إن هو لم يعمل على تحكيم كتاب الله. فغالبية المسلمين، تنظر إلى إقامة الدولة الدينية، على أنها فرض عين ديني؛ كالصلاة، والزكاة، والصوم. ولذلك يبقى عدم اقامتها مصدرًا مستمرًا للشعور بالتقصير ولتبكيت الضمير. هذا هو ما يجعل الفضاء العربي، لا يخرج من موجة تطرفٍ، إلا ليدخل في أخرى أكثر عنفًا. هذه الوضعية لا تنطبق على الثقافات الأخرى، كثقافات شرق آسيا، لأن دياناتها، لم تربط بين الروحانية التي تتشاركها كل الأديان، وبين إقامة الدولة الدينية. لذلك، لن تتحقق النهضة والتحديث، بالمعني الحضاري العميق، في السياق العربي، إلا من خلال الإصلاح الديني، فهو سياق ذو إشكالية خاصة، لا تزال تنتظر المعالجة الجريئة.
من العوامل الأخرى المهمة، عامل سلطة رجال الدين على عقول سواد الجمهور، وتأثيرها عليهم. فهي، أكبر بكثير، من سلطة المثقفين وتأثيرها عليهم. والتفات الجمهور العربي، خاصة الجمهور المسلم، إلى ما يقوله رجال الدين، أكبر بكثير، خاصة في المجتمعات الريفية، من التفاته إلى ما يقوله المثقفون. فرجل الدين أقرب إلى رجل الشارع من المثقف. كما أن المسجد، والكتاب المدرسي، ومراكز الطوائف، بل وأجهزة الإعلام، تبث الخطاب الديني، وهو مرتبط بالخطاب الرسمي للأنظمة الشمولية، التي تستخدم ذلك الخطاب، لتبقي على سيطرتها على الجمهور. هذه الدوائر المتمكنة، تستخدم لغة مختلفة جدًا من اللغة التي يستخدمها المثقف، ويسوق بها بضاعته في دوائر معزولة، شبه مغلقة. فالمثقف العربي يعاني بهذه الوضعية، من تهميش مركب؛ فهو مهمشٌ من ناحية السلطة، لأن السلطة لا تملك إلا أن تساوي الثقافة بالمعارضة لها. وهو مهمّشٌ من جانب الجمهور، لأنه ابتعد عن مجال الدين، واستخدم لغةً عصية على فهم الجمهور.
وبطبيعة الحال، فإن تهميش المثقف العربي ليس منحصرًا في ما تقدم. إذ أنه أكثر تركيبًا من ذلك. فمن الجوانب الأخرى لحالة التهميش المركب تلك، أن حواضن المثقف العربي ليست حواضن اجتماعية، بقدر ما هي حواضن رسمية حكومية، تقع، بصورة أو أخرى، تحت سيطرة السلطة السياسية للحكومات التي تحرص حرصًا شديدًا على إما أن يكون المثقف في صفها، أو لا يكون أبدًا. ولذلك فإن أوضاع المثقف العربي أوضاع شديدة الميوعة، ولا تنطبق عليها أوضاع المثقفين الأخرين في السياق الحداثي الأكثر استقرارًا، وتقدمًا. حاول المثقف العربي أن يقفز فوق واقعه، فعلق بالفكر الغربي، بل بنهاياته، بلا وعي نقدي كاف، وبغير إحساس كاف بالشقة التي تفصل بينه وبين جمهوره بسبب غلبة التأثيرات الأجنبية على وعيه. فالأفكار التي تربط المثقف بجمهوره لا يمكن أن تكون مستوردة، وإنما ينبغي أن تصعد إلى الواجهة حاملة الترياق الذي يُخرج الحداثة من الجوهر الحي للتراث، وهي مستندة على دعاماتٍ جرى تثبيتها في تربة الواقع ذاته. على الرغم من تعقيد طروحات المتصوفة العرفانية، خاصة كبار الأقطاب، نجد أن التصوف نجح في خلق حواضن اجتماعية للوعي الديني الوسطي، وللتسامح، واسعة الانتشار. نجح المتصوفة في تحقيق ذلك لأنهم استخدموا مصطلحي “الشريعة” و”الحقيقية” ودلالتهما في الموروث الصوفي، ليجسروا الهوة بين “العارف” و”المريد”. فالعارف يعامل الخالق بالحقيقية، وفي نفس الوقت يعامل الخلق بالشريعة.
أشار إلى جانب من جوانب اشكالية المثقف وتهميشه، زهير توفيق، في كتابه “المثقف والثقافة”، حين تحدث عن هامشية النخبة الثقافية العربية، مقارنة بالنخب العربية الأخرى داخل السياق العربي نفسه. وذلك، حين عقد مقارنة بين “النخب الثقافية العربية”، والنخب العربية الأخرى، التي أسماها، “النخب اللاثقافية”، وعنى بها النخب السياسية والاقتصادية. فالنخب الأخيرة، تتميز على الأولى بأنها ذات قدرات مادية، وذات مرتكزات طائفية وعشائرية، في حين تفتقر “النخب الثقافية” إلى المال وإلى السند العشائري والطائفي11.
ويطرق برهان غليون جانبًا آخر من هذه الإشكالية، مشيرًا إلى أن النخب البيروقراطية المثقفة في المجتمعات العربية لم تحظ، على سبيل المثال، بما حظي به المثقفون في روسيا المتفجرة بثورة الفلاحين. فالمثقفون العرب لم تقف وراءهم قوى اجتماعية متماسكة أو متسقة، ذات مستقبل تاريخي واضح، يسندون عليها ظهورهم، وهم يعملون على خلق نمط متكامل للحداثة12.
يقول الوضع القائم في أقطارنا، على اختلاف في الدرجة، إن هناك مجالين متوازيين، لا يتداخلان، إلا شكليًا، ولا يجري بينهما حوار جدّي منتج؛ هما مجال السلطة الدينية، ومجال سلطة المعرفة الحرة التي يروج لها المثقفون المشتغلون بقضايا التنوير، والتحديث، والنهوض الحضاري. فإذا استمر هذان المجالان في حالتهما الراهنة، من انعدام الاشتباك الحواري المعقلن، والهادئ، بينهما، فإن الجمهور سوف يظل، في قبضة السلطات الدينية، والطائفية والعشائرية، وسيبقى ماضوي التفكير، ماضوي التطلعات. وبناء عليه، سوف يتكرر انتكاس محاولات النهوض، كل حين وآخر. ومن ينظر إلى الصورة الكلية، منذ بداية النهضة العربية، حين واجهت الشعوب العربية تحديات الحداثة، يرى توالي الانتكاسات. بل بلغت الانتكاسات حدًا خرج به الفكر الماضوي، من مجرد رؤى تعشعش في العقول، ليصبح ظاهرة سياسية معسكرة، احتلت مساحات شاسعة في كل من سوريا والعراق، بل، تنذر بمزيد من التمدد حيثما تشكل نوع من الفراغ السياسي والإدراي.
يرى جورج طرابيشي أن التحديث التراثي، هو المقدمة الممهدة، والشرط الضروري لطورٍ أعلى، من التحديث يجيء بعده. ويعني طرابيشي، تحديدًا، التحديث اللاهوتي والفلسفي، فبغير تجديد يطال اللاهوت، ويحرر النص من النص، لن تجد الفلسفة، ولا التفكير الحر، سبيلهما إلى العقول. يتوقع طرابيشي أن تتوالى عملية التحديث التراثي، التي بدأت في نهايات القرن العشرين، عبر النصف الأول من القرن الحادي والعشرين. فإعادة النظر في التراث لابد لها، وهي تسير نحو تحرير العقول، من المرور بمرحلة تحديث للاهوت. فتحرير اللاهوت، في نظره، شرط لكي يصبح التجديد الفلسفي ممكنا. فالتحرير اللاهوتي، يحرر النص، من النص، أما الفلسفي فيحرر العقل من النص13.
ويتوقع طرابيشي، أن النصف الثاني من القرن الحادي والعشرين سوف يشهد النقلة التالية، المتمثلة في التحديث الفلسفي.
….يتواصل…
* قدمت هذه الورقة البحثية ضمن أعمال المؤتمر السنوي الرابع للعلوم الاجتماعية والإنسانية الذي نظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في مراكش – المغرب، في الفترة 19-21 آذار/ مارس 2015.
………………………………………..
1عزمي بشارة، الدين والعلمانية في سياق تاريخي، (ج – 1)، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة وبيروت، (2013)، ص 11.
2 فراس السواح، دين الإنسان: بحث في ماهية الدين ومنشأ الدافع الديني، (ط3)، دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة، دمشق، سوريا، (1998)، ص، ص، 19-20.
3 خالد سليمان وحيدر جواد، هادي العلوي: حوار الحاضر والمستقبل، دار الطليعة الجديدة، دمشق سوريا، 1999، ص، 68. 4 Huston Smith, Beyond the Postmodern Mind, Quest Books, (Ed 3) 2003, p. 209.
5 في حوار لروبرت كولز، عالم النفس الأمريكي، المشتغل بقضايا الروحانية، مع دوروثي داي، قالت دوروثي داي لكولز: أنت تقلل من شأن الشك كجزء ثابت في بنية الإيمان نفسها، وتلك حالة تنطبق على كل قرن من القرون. أنت ترد السبب في نشوء العلمانية، بشكل رئيس، إلى العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية. أنا لا أنكر أن للعلوم الطبيعية سلطة تدعم العلمانية اليوم. لكن، بحق السماء، لقد كان العالم العلماني موجودًا على الدوام، هنا، أو هناك. تلك هي القصة الكبيرة للعهد الجديد مع العهد القديم، وتلك، أيضًا، هي قصة البروتستانتية مع الكاثوليكية. أنت تنظر إلى جاليليو ونيوتن وأينشتاين وفرويد بوصفهم المدافع الكبيرة التي ظلت تدك معاقل الإيمان الديني، وتقضي على الروابط الدينية بين بني البشر. في نظري أن هؤلاء الناس ليسوا سوى جزء من قصة طويلة جدًا. راجع: Robert Coles, The secular Mind, Princeton University Press, Princeton, NJ, USA, (1999), p 40. 6 Morris Berman, The reenchantment of the world, Bantam Books, New York, NY, USA, (1984), p. 23
7 Ken Wilber, A brief history of everything, (3 Ed), Shambhala Publications, Boston, MA, USA, (2000), p
8 سورة المائدة، آية 44.
9 نفس السورة، آية 45
10 نفس السورة، آية 47
11 يرى زهير توفيق أن النخبة الثقافية في عالمنا العربي يتعذر ضبطها مفهوميًا وواقعيا، فهي أقرب ما تكون إلى السيولة المعرفية. هذا في حين نجد أن النخب الأخرى، السياسية والاقتصادية والعشائرية في فضائنا العربي، تملك، في واقعها المعاش، شرعية وجودها وحضورها، بقدر لا يمكن أن يتوفر للنخب الثقافية العربية. فالنخب الأخرى تتمتع بقدرات مادية ورمزية، جعلتها قادرة على فرض الأمر الواقع، بل واستدامته إلى حد كبير. هذه النخب “اللاثقافية”، قادرة أيضًا على تغييب الأسس التاريخية والمنطقية اللازمة لنقض وتقويض الأوضاع التي ثبتتها. فهي تتميز، على النقيض من النخب الثقافية، بقدرتها على انتاج السلطة والثروة، واستدامة السيطرة على المحكومين، واستثمار كدهم ووجودهم نيابة عن الطبقة المسيطرة. أما النخب الثقافية فليس لديها سلطة مادية تفرض بها سيطرتها. بل هي لا تستطيع تسليع وتسعير منتوجها الثقافي في مجتمع لم يصل بقعد درجة الطلب للمنتوج الثقافي. بل إن الثقافة، في تصور البعض، لا تزال خدمة عامة، ورسالة انسانية يطلع بها من يطلع بها تفانيا ونبلا ومجانية. ولذلك، لا تجد النخب الثقافية، أحيانًا، مخرجًا من أوضاعها الضاغطة سوى الانخراط في البنى الاجتماعية الأخرى لتسويغ وجودها، وتصعيد مطالب الآخرين، وإضفاء الشرعية والعقلانية عليها. راجع: زهير توفيق، المثقف والثقافة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، عمان، الأردن، 2013، ص 11-17. 12 برهان غليون، تهميش المثقفين ومسألة بناء النخب القيادية، (ط 2) في: المثقف العربي: همومه وعطاؤه، مركز دراسات الوحدة العربية، ومؤسسة عبد الحميد شومان، 2001، ص 85-118.
13 جورج طرابيشي، من النهضة إلى الردة: تمزقات الثقافة العربية في عصر العولمة، (ط2) دار الساقي، بيروت، لبنان، (2000) ص ص 43-44.
المصدر: صفحة الدكتور النور حمد